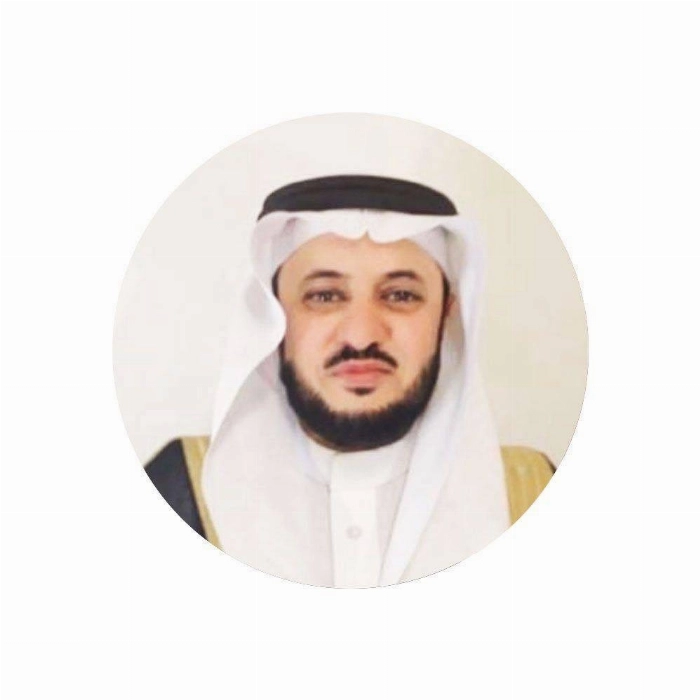لي مدة وأنا أمضي بعض الوقت متجولا في أرشيف الصحف المحلية خلال عقد الثمانينيات من القرن الفائت، أتهجى فيها الوجوه والأسماء، وأقرأ بين سطور الأحداث والمواقف والمقالات، وكحديقة واسعة أجدني أخرج في كل مرة بقطاف لذيذ من الأفكار والأسئلة، عن مزاج الناس بالأمس، عن أصغر القضايا وأكبرها في اهتمامات الشارع، وعن اللغة التي تختزن لون المرحلة ومزاجها.
ومن تلك القطاف التي كنت أشاطرها الأصدقاء أخبار وتعليقات على هامش القضية التي كبرنا على وقع أحداثها، رسمنا خيالاتنا حولها، بمثل ما خططنا لنا سطورا من الحماسة على هوامش دفاتر التعبير، فلسطين، بلاد الزيتون، والشمس، ووعود الحرية المؤجلة.. وجدتها تطل من كل الصفحات، الرياضة والسياسة والثقافة، وحتى صفحات الأطفال. كأنها ساحل بلا جزر، أو صيف ساخن بلا انتهاء، فباب الأخبار مفتوح على مصراعيه تجاه هذا البلد المنهوب.
شاهدت كثرا من الكتاب يقتربون منها بين حين وآخر، شاهدت لغتهم العالية، وحماستهم الكبيرة، عبارات وأوصاف تغرف من معين اللحظة إياها، كانت الانتفاضة بمثابة الذروة لهذا المشهد الحماسي في الكتابة، ملاحق، ومناسبات، ومواقف، ومقالات، احتشدت على حدود المشهد الساخن.. وفي واحدة منها كان المحرر يجول على أطراف الساحل في نزهة العيد، يسأل الناس عن أمنياتهم، فيلوحون له بتوقف حرب الخليج، وعودة فلسطين.
هل كان كل ذلك مجرد حصص تعبير؟ هكذا تأويل يحتمل الكثير، لكنه لا يصف حقيقة الموقف آنذاك، فبالأمس كما اليوم تتقدم أخبار تلك الأرض وتحتل مساحتها الخاصة من اهتمامات الناس، تخبو مرات، لكنها سرعان ما تشتعل في خواطرهم ثانية. ربما المناخ هو الذي تغير، كان العالم يخرج من حقبة الاستعمار بدخول الثمانينيات، وهذا ما يجعل الشعور بأن هذا الاحتلال سيزول على غرار محطات الاستعمار الأخرى التي عرفها العالم العربي هو السائد عند الناس، لم تكن فكرة ساذجة في أذهانهم وقتها، بل ترجمانا لشعور قومي طاغ كان يعيد ترتيب الخارطة العربية الممزقة، تلاقح معه وهج ديني يتصاعد بتصاعد خطاب الأمة الواحدة، إلى حد لا تشعر بالفوارق بين تلك الانتماءات المتغايرة حين الوقوف عند قضايا البلد المحتل.
هرمت القضية اليوم وهي تقترب من إكمال عقدها الثمانين، كما هرم كتابها من جيل الثمانينيات، الثقوب الصغيرة التي تسلل منها اتفاق أوسلو وما تلاه من وعود الحكم الذاتي على قطاع غزة والضفة الغربية، أعاد تكييف المشهد وخياراته، لغة أخرى بدأت تزاحم لغة الأمس، أصبح المشهد لبعض الوقت يشبه أحوال «اللاحرب» واللاسلم»، تخاصم الفلسطينيين في ما بينهم، وتخاصم حولهم بقية المتابعين العرب في تقييم المرحلة واستحقاقاتها، مكتسباتها وخسائرها، بيد أن الرغبة في السلام كطريق لمعالجة المشكلة أخذت تزحزح شيئا فشيئا من مساحة الخيارات الأخرى التي بدأت تتضاعف أثمانها، وتتضاءل في أذهان الناس إمكانية إنجازها.
هذا ما يفسر المسافة بين لغة الأمس واليوم، بين كتابات الصحف القديمة وتلك الحديثة، تراجعت أشياء وتقدمت أخرى، فكان أثر ذلك حاضرا في طبيعة المقاربة الإعلامية للقضية، كما وكيفا، لا يمكن القول بتحول في ضمائر الناس، ولا إنسانيتهم، بل هي تجليات اللحظة بكل ثقلها الاجتماعي والثقافي والسياسي، لحظة لا تعيش كثافة الذاكرة، وأسئلتها، لكنها تعيش على تخوم خيبات طويلة، لخسارات لا تعرف الانتهاء، ولا الحلول الوشيكة، إلى الحد الذي يصبح كل حديث عنها هو حديث عن اليأس، والعجز، والحيرة، وهذا شعور كاف لحمل البعض على عدم اليقين بفهم اتجاهات الأحداث، فضلا عن إيجاد حلول لها.